
مرحبا بك سي عبد اللطيف. أشكرك على رحابة صدرك وعلى الوقت الذي منحتنا للإجابة على هذه الأسئلة.
س: لماذا تكتب القصة وليس الرواية؟
ج: وقعت تحت تأثير القصة وأنا بعد تلميذ في الثانوي، أواسط الثمانينات، فكنت أتابع ما ينشر من قصص في الملاحق الثقافية المغربية والمجلات، كما كنت أقتني مجموعات قصصية لنجيب محفوظ وإدريس الخوري وإبراهيم بوعلو وأحمد صبري ومحمد زنيبر… فشرعت في محاولاتي القصصية الأولى، مسكونا بأمل أن أصبح كاتبا أحظى بالنشر في الجرائد. ولعل جاذبية القصة كانت تكمن بالنسبة إلي آنذاك، إلى جانب لذتها الفنية، في قصر حجمها، تداولها على نطاق واسع في وسائط النشر، وقابليتها للنشر على صفحات الصحف والمجلات. وكان لاحتضان أولى محاولاتي في الصفحات المخصصة للأدباء الشباب (“حوار” بجريدة العلم، “على الطريق” بجريدة الاتحاد الاشتراكي، “إبداع ونقد” بجريدة أنوال….) أثر حاسم في اهتمامي المتزايد بالقصة، قراءة وتأليفا. وسيتضاعف هذا الاهتمام مع نجاحي في النشر بالملاحق الثقافية والعديد من المجلات، ثم مع فوزي بجائزة الشارقة للإبداع سنة 2005. لقد حاولت مع ذلك، كتابة الرواية مرات متكررة، وكانت محاولتي الأولى حين كنت تلميذا في السابعة عشر من عمري، إلا أن محاولاتي باءت بالفشل، بسبب عدم قدرتي على وضع تصميم كلي للرواية، وافتقادي لمادة حكائية تنبسط على امتداد عشرات الصفحات، فضلا عن خمود همتي وانطفاء حماسي بعد أسابيع من العكوف على الكتابة. من المرجح أني أحب الاشتغال في مساحة محدودة، مثلما الشأن بالنسبة للفنان الفوتوغرافي الذي يتفنن في التقاط صورة دالة لموضوع لا يتجاوز حيزا صغيرا (أستحضر هنا مقارنة خوليو كورتاثار بين القصة والرواية)، وأجد مشقة في ترك قلمي يرتاد مساحات شاسعة مأهولة بالشخصيات والأحداث والفضاءات، مثلما يصنع مخرج الأفلام. إن القصة فن الصلاة الخاشعة في محراب اللحظة. وإذا كان هذا الخشوع يكلفني كثيرا من الانهمام بموضوع القصة لأسابيع أو شهور، وكثيرا من فناجين القهوة لتحويل الموضوع المختمر إلى بناء من الكلمات على الورق، وكثيرا من الصبر والتركيز للتنسيق بين مكونات القصة، معملا فيها إزميل التشذيب والتهذيب، مدققا في توظيف الكلمات والجمل، في انتقاء الملائم من الأفعال وردود الفعل، وفي اختيار المواد المناسبة لتحقيق الأثر المراد…، إذا كان الأمر على هذا النحو، فإن وقتي وأعصابي وقريحتي ستعجز لا محالة عن الاشتغال على نص طويييل. لقد صارت القصة هوسا بالنسبة إلي، واستوطنت روحي، وإن كنت أرحب بالرواية متى أسعفتني.
س: ماذا عن أدوات الكتابة الجيدة التي تهديها للأجيال الشابة بعد هذه الرحلة مع كتابة القصة؟
ج: لا أزعم أني أمتلك أدوات أو مستلزمات الكتابة الجيدة، ولكن حسبي أن أستلهم تجربتي المتواضعة في تأليف القصة وقراءتها، لأشير إلى أدوات أو مستلزمات تحتاجها كل قصة تطمح أن تحظى بإعجاب القارئ:
أولا، القصة نثر يُجترَح باللغة وفيها، ولذلك لابد لكاتب القصة أن يملك زمام اللغة، بحيث يكون قادرا على تطويعها لتصوير الشخصيات والأحداث، ورسم الأمكنة والأزمنة، والتعبير عن المواقف والأحاسيس والمشاعر. الدقة في التصوير والرسم والتعبير مطلب جوهري، فضلا عن اكتساء لغة القصة لرشاقة تجعلها سلسة ممهورة بإيقاعات محببة إلى النفس، خفيفة يسري فيها ماء الشعر، وظيفية مناسبة للمقام، كثيفة تتوفر على خصوبة دلالية، وموحية تخفي أكثر مما تكشف، وتلمح أكثر مما تصرح.
ثانيا، تعد الحكاية مادة القصة، فأنت تقص لتروي حكاية، لها بداية ونهاية، مع ما تتيحه طريقة القص من إمكانية للتقديم والتأخير في مجرى الأحداث. لذا فإن القصة التي تستعيض عن الحكاية بالنظرات التأملية، أو الخطاب المقالي، أو التهويم المجرد، تخفق في أن تصير قصة. ولا يعني هذا أن القصة تستبعد أسلوب التأمل والمقال والتجريد، وإنما تصهر هذه الأساليب في ثنايا الحكاية، على نحو يصبح معه وجودها ضرورة تستلزمها طبيعة الشخصية والموقف والحدث…
ثالثا، تقوم القصة على بناء محكم يطرز عناصرها بشكل منظم، يستبعد العشوائية والفوضى، ويمنح كل عنصر دورا يتضافر ويتفاعل مع العناصر الأخرى لإنتاج أثر كلي. إن العناصر المكونة للقصة تخلق كيانا ديناميا متسقا، لا محل فيه لتفصيل زائد أو جزء متنافر مع الأجزاء الأخرى، ولا مكان فيه لنتيجة (خاتمة القصة) تتناقض مع المقدمات (البداية والعرض).
رابعا، لا يفلح القاص في شد اهتمام المتلقي إن لم يخلق توترا في نسيج القصة، تنطلق شرارته من بدايتها لتتأجج رويدا رويدا حتى نهايتها، حيث يمكن أن يخلد التوتر إلى الخمود مع بلوغ ذروة القصة، ويمكن أن يستمر ليبقى حاضرا في نفس القارئ بعد فراغه من القراءة.
خامسا، تفاعلُ خبرة المعيش اليومي والقدرةُ على التخييل وحصيلةُ المعرفة من أهم مستلزمات القصة، إذ يفترض في القاص أن يمتلك تجربة حول واقع الناس في المجتمع والحياة، وأن يكون قادرا على التقاط وانتقاء لحظات دالة من هذه التجربة، وتحويلها عبر طاقة الخيال إلى قصة تستند إلى قدر من الإلمام بالحقول المعرفية المختلفة (سواء تعلقت بالنفس أم الاجتماع أم الثقافة أم الذوق…). إن انصهار ثمار الخبرة الواقعية مع الطاقة التخييلية والتجربة المعرفية، في نسيج قوامه التصوير لا التقرير، التلميح لا التصريح، هو ما يخلق القصة الجيدة.
سادسا، تحتاج القصة إلى توظيف مجموعة من التقنيات أهمها السرد والوصف والحوار والمونولوج، وكلما كان نسيجها قائما على خلق توازن دقيق بين هذه التقنيات، كانت أقرب إلى التأثير في المتلقي على النحو المراد.
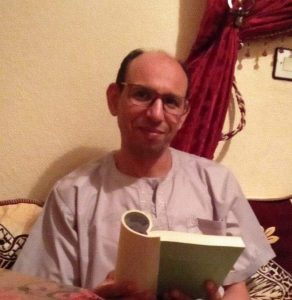
س: أين تضع نفسك بين كتاب جيلك؟
ج: أحاول أن أكتب قصة تستلهم منجزات القصة المغربية والعربية والعالمية، مشتبكة مع أسئلة الواقع والحياة، منفتحة على أفق الخيال، ومنتجة للجمال، دون تقليد أو جمود على شكل محدد. ولا شك أن القارئ – العادي أو العالم – هو المخول لتحديد وضع تجربتي القصصية في سياق مختلف التجارب.
س: بعد هذه الرحلة الطويلة، كيف ترى واقع القصة القصيرة؟ وهل ترى أن هناك شبابا بيدهم حمل مشعل القصة المغربية؟ وبمن تشيد ممن ترى أن بمستطاعه الأخذ بيد “طفلة الأدب”؟
ج: بسبب ضيق الوقت وإكراه الإمكانيات المادية، ليس بوسعي أن أتابع كل ما تخرجه المطابع من إصدارات قصصية جديدة. فقراءاتي تسلك طريق الانتقاء، وتخضع أحيانا لما تلقيه الصدف بين يدي. لذلك يبقى تقييمي لواقع القصة المغربية اليوم مجرد انطباع ذاتي. وعموما، أسجل تراكما ملحوظا في إنتاج القصة، واهتماما واسعا بجنس القصة، رغم المنافسة الضارية للرواية في السنوات الأخيرة، بدليل حجم الإصدارات، وحجم الاهتمام النقدي والذوقي، وحجم المجموعات والنوادي والملتقيات المخصصة للبحث في القصة والاحتفاء بها. كما أسجل تنوعا في أساليب وطرائق وتيمات كتابتها، إذ هناك قصص تحافظ على العروض القصصي الكلاسيكي، وأخرى تنحو منحى تجريبيا، وثالثة تنهج مسلكا توفيقيا. وهناك قصص تمتح مادتها من واقع حياة الناس، وأخرى تتعالى على الواقع صانعة عالما فانطاستيكيا أو غرائبيا، وثالثة تختار موقف البين بين. وهناك قصص تستعمل لغة فصيحة أو متفاصحة، وأخرى تعتمد لغة بسيطة وقد لا تأنف من استلهام بنية اللغة الدارجة، وثالثة تستند إلى لغة وظيفية تشتغل وفق قاعدة “لكل مقام مقال”. وهناك قصص تتأسس على مبدأ الاقتصاد والتكثيف والإيحاء، وأخرى متدفقة ثرثارة تشغل منطق الحكي الروائي. وفي خضم هذا التراكم على مستوى الإنتاج، لا تنتزع إعجابي سوى مجموعة محدودة من القصص، ولا أعثر على تفرد وتميز في الإنجاز إلا لدى أسماء معدودة. لكني مع ذلك، أنزع إلى التفاؤل، وأحدس بمستقبل واعد للقصة في بلدنا.
س: هل هناك شخصية، من شخصياتك المتخيلة، تركت فيك أثرا عميقا؟ وما هي أقرب القصص إليك؟
ج: أعتمد مسلكين في خلق شخصيات قصصي: المسلك الأول يقوم على استلهام الشخصية من تجربة المعيش اليومي، والثاني يقوم على ابتداع الشخصية استنادا إلى الخيال الذي ينشط تحت تأثير القراءة أو المشاهدة. وكل صنف من شخصيات القصة يسكنني فترة من الزمن، فتختمر معالمه داخل رأسي، قبل أن أجرؤ على صياغته على الورق، إلا أن لعملية الكتابة دورا أساسيا في تشكيل الصورة النهائية للشخصية. لذلك فإن العديد من شخصيات قصصي تترك أثرا في وعيي ووجداني، وتبقى حاضرة في ذاكرتي كما لو كانت شخصا من دم ولحم. ومن بين الشخصيات القصصية المؤثرة في روحي، أذكر شخصية قصة “خفافيش السبت”التي تعاني الوحشة بعيدا عن مسقط الرأس، وشخصية قصة “الأعزل” التي تكابد معاناة الشيخوخة، وشخصية قصة “البيت الرمادي” التي تحرس بيتا مثيرا للحيرة والقلق بسبب علاقته بالسلطة، وشخصية قصة “اللحن” التي تفقد حياتها في السيل جراء بحثها عن اللحن المطلق، وشخصية قصة “ملح للحساء” التي تختبر محنة العمى وسط لا مبالاة فلذات الكبد، وشخصية قصة “علبة الثقاب” التي تنهوس بالإبداع في ظل جحود الأبناء. ولعلي قد أشرت إلى بعض القصص الأقرب إلى نفسي.
س: الكتابة كمهنة في العالم العربي ما تزال تحبو من ناحية كونها ليست مصدرا للعيش. ماذا تقول للأجيال الجديدة التي تريد أن تعيش على الكتابة؟
ج: يبدو من قبيل السخرية الحديث عن الكتابة كمهنة في العالم العربي، فالكاتب لا يملك، في المجتمع العربي، وضعا اعتباريا يعترف بدوره الفعال في إنتاج الجمال، وصياغة الوعي، وبلورة الذوق، والتعبير عن الوجدان والفكر والسلوك… ويعود ذلك إلى غياب الوعي بالأهمية القصوى للأدب والفكر في تحضر الأمم. لذلك ليس من المستغرب أن تستفحل ظاهرة العزوف عن القراءة، وأن يحتل الكتاب مكانة ثانوية في اهتمامات المواطن العربي، الشيء الذي ينعكس سلبا على تداول الأدب والفكر، ورواج سوق المنتوج الأدبي والفكري. وبالتالي، ليس بوسع الكاتب أن يمتهن الكتابة ويتفرغ للعكوف في محرابها ويأمل في التعيش على ما تبدعه قريحته. لا يبقى أمام الكاتب سوى أن يمارس الكتابة بوصفها ضرورة أنطولوجية، أو بوصفها هاجسا ذاتيا، أو بوصفها نمطا خاصا من الوجود تمليه رغبة الذات في تحقيق توازن نفسي، وفي الإسهام في النهوض بالإنسان عبر إنتاج أثر جمالي ومعرفي.
س: ظاهرة الانتشار السريع للأدباء والأديبات هل تعكس أزمة ما؟
ج: ربما يشير السؤال إلى سهولة النشر التي أصبحت متاحة بفضل وسائط التواصل الاجتماعي ومواقع العالم الافتراضي. يظهر من جهة، أن هذه السهولة تزيح عوائق النشر التي كانت قائمة في مرحلة سيادة المطبوعات الورقية، وتُشْرع الباب على مصراعيه أمام محاولات المتعاطين للكتابة، مما يوفر تراكما في الإنتاج. لكن يظهر، من جهة أخرى، أن هذه السهولة تفضي إلى اختلاط الغث بالسمين، والوقوع في فوضى المعايير الفنية والضوابط الجمالية، وشيوع أدبيات المجاملة والمحاباة. لذلك يبقى من الضروري أن يحضر صوت النقد الرصين، وصوت الذوق الرفيع، لإلقاء الضوء على المنجزات الأدبية، وتمييز جيدها من رديئها، ووضع النقط على حروف الإبداع. ولا يخامرني الشك في كون التاريخ سيقول كلمته ولو بعد حين، فلا يمكث في الأرض إلا ما كان حائزا لصفة الإبداع الحق، أما “الزبد فيذهب جفاء”.
س: قلت لي أثناء حديثنا عن الناشر إنه لا يقدم كثيرا على نشر المجاميع القصصية حتى وإن حازت على جوائز كبرى. وأن لك عملين مخطوطين ينتظران ناشرا؛ متى سيرى قراؤك أعمالك القادمة؟ وهل ستضرب لهم ولهن (القراء والنقاد) موعدا للصدور؟
ج: يبدو أننا نفتقد الناشر الذي يحركه هاجس الإبداع، فيكون همه هو اكتشاف المواهب والطاقات الإبداعية، واحتضان الأعمال المتفردة، بغض النظر عن جنس الإبداع. فبما أن الرواية أصبحت تعرف رواجا بسبب دعاية الجوائز بوجه خاص، فإن الناشر، في غالب الأحيان، صار يولي كل اهتمامه لهذا الجنس بهدف تحقيق المكسب المادي الذي تؤمنه نسبة المبيعات. لذلك، فالقاص يكابد إبداع أعمال جديدة تبقى حبيسة الرف، ولا يعثر على ناشر يعفيه من تكلفة النشر ويضمن لعمله توزيعا يضعها بين يدي القارئ، حتى وإن كان عمله متوجا بإحدى الجوائز، فلا يبقى أمام القاص سوى أن يطبع عمله على نفقته الخاصة. إلا أن ما يحدث في الغالب مخيب ومحبط لمسعاه، إذ يكتفي بتوزيع نسخ من عمله في مكتبات مدينته، وتظل أكوام من النسخ قابعة في كراتين بإحدى زوايا بيته، ولأنه يطمح إلى اطلاع القراء على عمله، فإنه يشرع في إهداء نسخ من عمله إلى الأصدقاء والمعارف. ليس بوسعي، إذن، أن أضرب للقراء موعدا محددا لصدور عملين قصصيين جديدين (“ملح للحساء”، و”البالونة في الأعالي”)، فليس أمامي سوى ما تسمح به إمكانياتي المادية.
س: هلا حكيت لنا شيئا من الطرائف التي وقعت لك مع كتاب أو قراء؟
ج: أنبش في ذاكرتي بحثا عن أحداث طريفة أودالة، لها صلة بالكتابة، فتسعفني بهذه النتف:
* حدث مرة أن كتبت قصة طويلة للأطفال تحت عنوان “حكاية ابن الحطاب”، واتفقت مع أحد الأصدقاء على إنجاز رسوم لها، وبما أن جزءا من أحداث القصة يدور في بلاد الأندلس، فقد اعترض صديقي على وجود عربة تجرها الخيول، مبررا ذلك بكوننا – نحن المغاربة والعرب- لم نعرف في تاريخنا استعمال العربة إلا مع قدوم الاستعمار، فكان جوابي أني لا أكتب قصة تاريخية تراعي معطيات الواقع، فأنا أمنح نفسي حرية تخيل ما يلائم أحداث قصتي، ورددت على مسمعه قول غارسيا ماركيز: ((ما أعظم أن تكون لدى الكاتب حرية أن يضع مقهى “دي لاباروكا” حيث يشاء)).
* كنا قد أودعنا نسخا من إصداراتنا الجديدة بإحدى المكتبات، وكنا، من فترة لأخرى، نقصد المكتبة لتفقد نسبة المبيعات. وذات مرة أخذ صديقي الكاتب لحسن باكور يحصي نسخ كتابه، ونظر إلي ضاحكا، وقال في نبرة دعابة: يبدو أن عدد النسخ قد زاد! قاسمته الضحك، ودندنت: سلمت عليك الغالية! ما بايعة ما شارية!
ومنذ ذلك اليوم، كلما زار أحدنا المكتبة، وسأله صاحبه عن نسبة المبيعات، يرد ضاحكا: سلمت عليك الغالية! ما بايعة ما شارية!
* أجرى أحد الكتاب حوارا معي حول تجربتي القصصية، فنشره بإحدى الصحف العربية الذائعة الصيت، حيث كنت قد نشرت، من قبل، قصة قصيرة جدا، وحيث نشر ناقد قراءة في مجموعة من قصصي.غمرتني سعادة قصوى وأنا أرى نص الحوار مرفقا بصورتي الشخصية، يشغل حيزا يعادل نصف الصفحة الثقافية للصحيفة. قلت في نفسي: فلأنتهز الفرصة، ولأشرع في نشر قصصي بالصحيفة. أنهيت نسخ إحدى قصصي بخط اليد، وأرسلتها بالبريد إلى الصحيفة العربية ذائعة الصيت. تابعت عبثا أعداد الصحيفة فترة من الزمن، مقلبا بين صفحاتها عن قصتي. لم أتوصل برد من رئيس التحرير، ولم تر قصتي النور على صدرها. أرسلت قصصا أخرى، لكن باب الصحيفة ظل موصدا في وجهي. كانت خيبتي مضاعفة: كيف يقبلون بنشر حوار مع الكاتب، ويرفضون نشر نصوصه؟!
![]()








